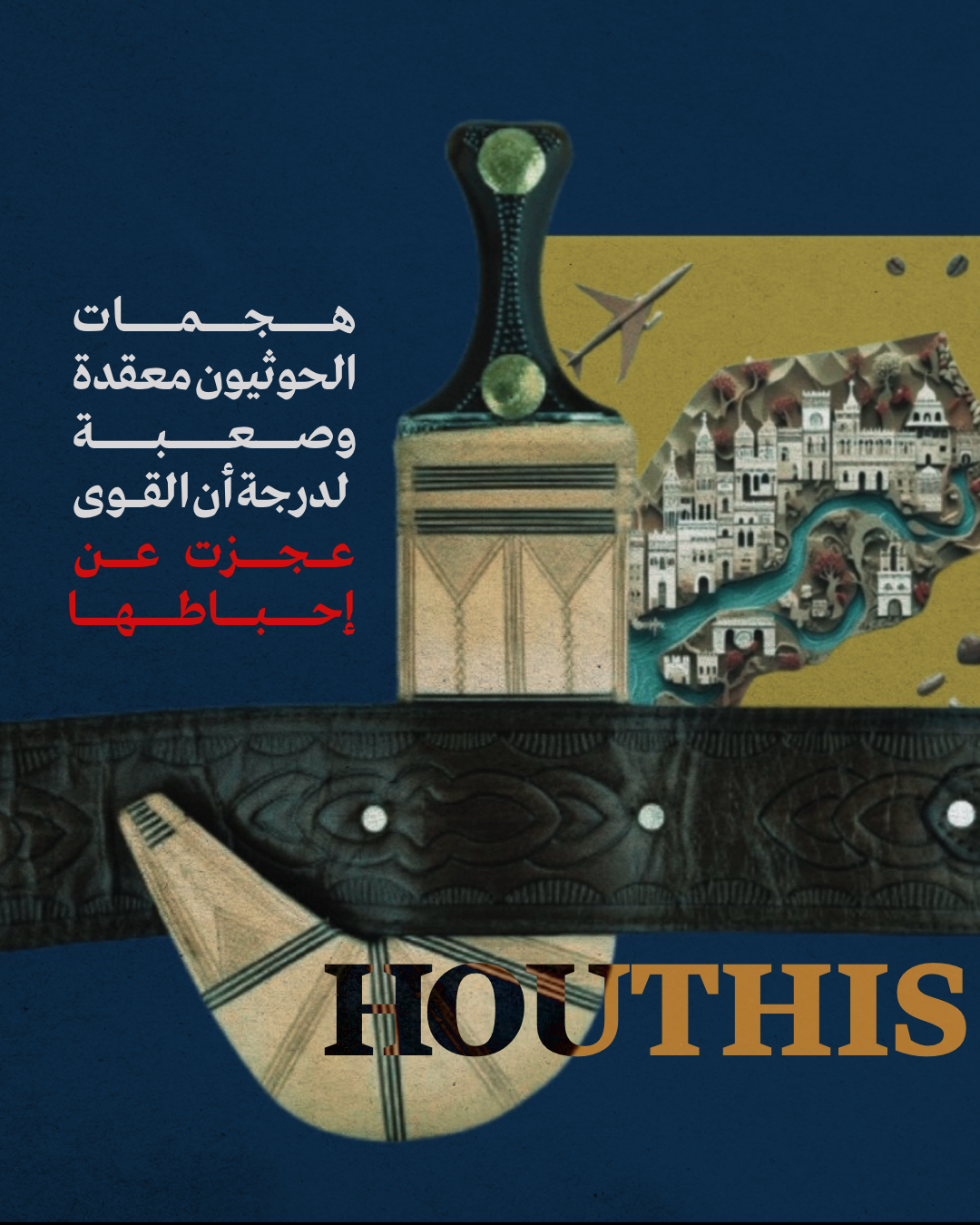![]()
تداعيات غزة: الجغرافيا السياسية لحملة الحوثيين في البحر الأحمر
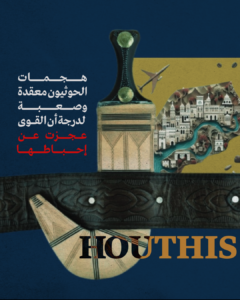
من هم الحوثيون؟
حركة الحوثيين ، المعروفة رسميًا باسم “أنصار الله”، هي جماعة سياسية وعسكرية ودينية ظهرت في شمال اليمن في تسعينيات القرن الماضي. ينتمي الحوثيون دينيًا إلى الطائفة الزيدية الشيعية، مع أنهم يعتمدون بشكل أكبر على كتاب “الملازم” المطول الذي ألفه حسين الحوثي، والذي يُعدّ النص الأساسي لفكرهم، ويُعتمد عليه بشكل متزايد كنص مقدس.
في حين كان للزيديين بعض المكانة كـ”إمامة” أو دولة في شمال اليمن من عام 1918 إلى عام 1962، إلا أن أراضيهم لم تكن سوى زاوية صغيرة من شمال غرب اليمن الحالي، وكان حكمهم متقلبًا. أسس حسين الحوثي حركة الحوثي الحديثة في التسعينيات وقادها حتى وفاته في عام 2004. ثم انتقلت القيادة إلى شقيقه عبد الملك الحوثي . واجه الزيديون تهميشًا اقتصاديًا وسياسيًا ودينيًا في العقود التي تلت سقوط الإمامة في عام 1962، والتي تحولت في النهاية إلى سلسلة من الحروب في عام 2004 حتى اندلعت الربيع العربي. خلال ذلك الوقت، قاد الحوثيون ست جولات من القتال ضد الحكومة اليمنية، وفي الجولة الأخيرة من الصراع خلال عامي 2009 و2010، انخرطت المملكة العربية السعودية ردًا على توغل حوثي عبر الحدود .
بدافع من عدم الرضا عن معاملتهم خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي قادته الأمم المتحدة والذي أعقب الإطاحة بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح في فبراير 2012، تولى الحوثيون دور الحكم في اليمن من خلال الاستيلاء على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014. دفع الاستيلاء على المدينة المملكة العربية السعودية إلى زيادة تورطها ودخول الصراع على رأس تحالف عربي، مما أدى إلى تدويل الحرب الأهلية. يعيش ثلثا سكان اليمن اليوم في مناطق يسيطر عليها الحوثيون. داخل اليمن، أنشأ الحوثيون هيئتين حاكمتين في عام 2016: المجلس السياسي الأعلى، الذي يعمل كهيئة تنفيذية، وحكومة الإنقاذ الوطني. اكتسب الحوثيون شعبية في البداية على أساس مناصرة المظالم المشتركة من خلال الوعد بمعالجة الفساد وحماية الجماهير من رفع دعم الوقود. وفي الآونة الأخيرة، لفتوا الانتباه العالمي لهجماتهم على الشحن الدولي في البحر الأحمر دعماً لفلسطين.
الحوثيون يرتبطون بإيران
يُعد دعم الحوثيين جزءًا من استراتيجية إيران الكبرى لترسيخ مكانتها كقوة عسكرية بحرية في المنطقة وخارجه وذلك لحماية تدفق صادراتها النفطية في ظل العقوبات. ووفقًا لمحللين إيرانيين ، لم يحظَ الحوثيون باهتمام ودعم إيران إلا بعد أن أظهروا أداءً جيدًا في ساحة المعركة في المراحل الأولى من الحرب مع المملكة العربية السعودية عام 2015، وبعد ذلك توطدت الشراكة. ومن خلال الموقع الاستراتيجي للحوثيين في مضيق باب المندب، تسعى إيران إلى كسب نفوذ في الصراعات الإقليمية، ومواجهة الضغوط الأمريكية في المنطقة، والالتفاف على العقوبات الأمريكية، والرد إذا تم الاستيلاء على ناقلات النفط التابعة لها في البحر الأحمر أو المحيط الهندي أو مناطق أخرى. في ذلك الوقت، بدا أن إيران قد استنتجت أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها ستكون دائمة على الأرجح. ونظرًا لهدف إيران المتمثل في الحفاظ على بنيتها التحتية النووية ومكانتها كدولة على عتبة نووية، فإن احتمالية التوصل إلى اتفاق أمريكي-إيراني جديد لا تزال ضئيلة، حتى مع انتخاب رئيس إيراني جديد في يوليو 2024.
يمكن النظر إلى العلاقة بين إيران والحوثيين من منظورين مختلفين. فمن جهة، تتمتع إيران، بصفتها داعمة لهم، بنفوذ هائل على الحوثيين. فعلى سبيل المثال، لم تُستأنف هجمات الحوثيين على الأهداف المدنية والبنية التحتية في السعودية منذ الاتفاق الإيراني السعودي على استعادة العلاقات الدبلوماسية في مارس/آذار 2023.
من ناحية أخرى، تم تجاهل دور وكلاء إيران. قبل عقد من الزمان، كان الحوثيون يُعتبرون قبيلة من الجبال تستخدمها إيران، لكنهم أثبتوا أنهم طلاب ماهرون: فقد وفروا لإيران مواقع لإدارة راداراتها وصواريخها، وتلقوا تدريبًا من الإيرانيين لإخفاء وتشغيل أنظمة صاروخية متطورة. وبينما لا يزالون يعتمدون على الدعم الفني من إيران، إذا جاء يوم لم تعد فيه إيران جزءًا من المعادلة، فإن قدرات الحوثيين على شن هجمات متطورة ستبقى قائمة. علاوة على ذلك، لم يلتزم الحوثيون دائمًا بإيران في الماضي، بما في ذلك استيلاء الحوثيين على صنعاء عام 2014، والذي كان ضد النصيحة الإيرانية ونابعًا من اتفاق مع الرئيس اليمني السابق المخلوع علي عبد الله صالح.
في الآونة الأخيرة، شكّلت أفعال الحوثيين الديناميكيات الإقليمية للحرب في غزة. ويُقال إن وابل الصواريخ والطائرات المسيرة الانتقامية الذي شنته إيران على إسرائيل بعد الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق أوائل أبريل/نيسان 2024 كان مستوحى جزئيًا من تشكك الحوثيين وحزب الله في عزم إيران على مواجهة إسرائيل. ومع ذلك، فإن الهجمات الحالية على الأهداف البحرية في البحر الأحمر تُنسّق بلا شك مع إيران لضمان عدم انحراف أي شيء عن نواياها.
ويجب فهم العلاقة بين إيران والحوثيين على أنها طريق ذو اتجاهين، حيث تتمتع إيران بالنفوذ الأعلى لإجبار الحوثيين على تقليص عملياتهم في البحر الأحمر، ولكن الحوثيين يتمتعون بقدر معين من القوة لتشكيل السياسات والإجراءات الإيرانية أيضاً.
هجمات الحوثيين على السفن
يُعد البحر الأحمر أحد أهم ممرات النقل المائي في العالم. يمر عبره ما يقرب من 15% من التجارة البحرية العالمية ، بما في ذلك 30% من حركة الحاويات العالمية، و12% من النفط العالمي المتداول بحرًا، و 8% من الغاز الطبيعي المسال العالمي . ورغم أن مجتمع الشحن الدولي قد عمل سابقًا في بيئات سريعة التغير ومليئة بالتحديات، إلا أن هجمات الحوثيين المستمرة والمتصاعدة تُشكل تهديدًا بالغ التعقيد والصعوبة لدرجة أن القوى العالمية الكبرى عجزت عن إحباطه.
في نوفمبر 2023، أعلن الحوثيون عن نيتهم مهاجمة سفن شحن مرتبطة بإسرائيل للرد على ما اعتبروه استهدافًا غير متناسب للسفن الإسرائيلية على غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. معظم المعلومات التي يستخدمها الحوثيون لاختيار أهداف مناسبة من بين السفن المارة على طول سواحلها متاحة للجمهور من خلال قواعد بيانات حركة المرور البحرية على الإنترنت، ولكن كانت هناك بعض حالات التضليل والضربات العرضية على السفن التابعة لدول عدم الانحياز. وقع أول هجوم حوثي موثق على الشحن المدني في 19 نوفمبر 2023، عندما اختطف الحوثيون ناقلة مركبات، واحتجزوا طاقمها حتى يومنا هذا. منذ ذلك الحين، تعرضت أكثر من 40 سفينة للهجوم بأنواع مختلفة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم في مارس 2024.
انخفض الشحن بشكل حاد في البحر الأحمر منذ بدء الهجمات، حيث أعادت العديد من السفن، وخاصةً تلك التابعة لإسرائيل أو الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية، توجيه مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، مما يضيف أسبوعين من وقت العبور ويزيد من تكاليف الوقود. وقد أدى خطر الهجوم إلى زيادة أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بنسبة تصل إلى 250% للسفن التابعة لإسرائيل ، بالإضافة إلى تكاليف الطاقم وأسعار الشحن. ويعتمد تحديد السفن التي تعبر، مع مراعاة المخاطر، على عقد كل سفينة، وما إذا كان يتضمن بندًا خاصًا بالحرب، وما إذا كان المالك على استعداد لدفع أقساط التأمين ضد الحرب المرتفعة بشكل كبير.
تستطيع السفن التي تعبر البحر الأحمر تطبيق أفضل ممارسات الإدارة (BMP) 5 ، وهي سلسلة من الإجراءات التي طُوّرت لمكافحة القرصنة الصومالية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي نجحت في الحد من تلك التهديدات، ولكنها غير مصممة للدفاع ضد الصواريخ والطائرات المسيرة. وقد زوّدت بعض السفن بحراس مسلحين وتواصلت مع فرق العمل البحرية، وأوقف العديد منها أجهزة التتبع أو وضع عليها علامات، مثل “ليس مع إسرائيل”، وهذه الأخيرة إشارة للحوثيين بأنهم غير تابعين لإسرائيل وينبغي السماح لهم بعبور المنطقة.
في ديسمبر/كانون الأول 2023، أطلق تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عملية “حارس الرخاء” لمواجهة هجمات الحوثيين، وتلتها عمليات أخرى، بما في ذلك غارات جوية نفذتها الدول التي حفّزت هذا الجهد. ورغم أن الحملة اعتُبرت ناجحة جزئيًا، إلا أن الهجمات لا تزال مستمرة، واضطر قطاع الشحن إلى التكيف مع المخاطر. في يوليو/تموز، شنّت إسرائيل غارة جوية على ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر، والذي يسيطر عليه الحوثيون، ردًا على هجوم بطائرة مسيرة حوثية على تل أبيب، أسفر عن مقتل شخص واحد.
دوافع هجمات الحوثيين والرادعات المحتملة
هناك عدة دوافع محتملة وراء هجمات الحوثيين البحرية. لا تزال الجماعة بحاجة إلى موارد، بما في ذلك الوصول إلى الموانئ وشحنات الغذاء والوقود. ومع ذلك، فإن هذه الاعتبارات تطغى عليها القوة الناعمة التي قد يكتسبونها. وصلت الحرب المستمرة منذ تسع سنوات في اليمن إلى طريق مسدود هش منذ انتهاء الهدنة الرسمية بين الحوثيين والتحالف العسكري بقيادة السعودية أواخر عام 2022، لكن موقف الحوثيين داخليًا بدأ يتفكك في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وبينما تُدفع هذه الحملة العنيفة ظاهريًا لمساعدة فلسطين، وتتماشى مع إدانة الحوثيين الراسخة لليهود وإسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن هناك تيارًا خفيًا من الانتهازية استغله الحوثيون منذ أواخر عام 2023.
لقد أدى دعم غزة وتحدي الغرب في هذه العملية إلى زيادة شعبية الحوثيين محليًا ودوليًا، حيث يُشار إليهم بشكل متزايد على أنهم القادة الشرعيون لليمن. وقد تعززت حملة الحوثيين المناهضة للشحن البحري من خلال الاستخدام الذكي والناجح للجماعة لرسائل وسائل التواصل الاجتماعي ، وغالبًا ما تستخدم مقاطع فيديو موسيقية قصيرة جذابة، بما في ذلك الأغاني الداعمة للقضية الفلسطينية. وقد تم تداول هذه على نطاق واسع في العالم العربي وخارجه، ويبدو أنها مصدر للقوة الناعمة للحوثيين. قد تكون الولايات المتحدة أو حلفاؤها حذرين من مهاجمة الحوثيين بشكل مباشر في هذه المرحلة لأن هذه الإجراءات قد تزيد من شرعية حركة الحوثيين وشعبيتها، مع تدمير الجمود الحالي، وإن كان هشًا، على الأرض في اليمن.
في الوقت نفسه، استطاعت إيران، التي لا ترغب في بدء مواجهة شاملة مع إسرائيل، استخدام الحوثيين كوسيلة منخفضة المخاطر للتعبير عن دعمها لحماس. اليمن بعيد جغرافيًا عن إسرائيل لدرجة أن معظم صواريخ الحوثيين التي زودتها بها إيران لم تُسبب أضرارًا جسيمة، مع أن هذا الوضع بدأ يتغير في يوليو 2024. في وقت سابق، وصلت بعض الصواريخ ذات التدمير المحدود إلى العقبة وأراضٍ على الجانبين الأردني والمصري من الحدود الإسرائيلية مع إيلات. تُفهم هذه الضربات رمزيًا على أنها وسيلة لإيران لرفع أو خفض مستوى التهديد دون خوف فعلي من رد فعل إسرائيلي مباشر.
فيما يتعلق بالحلول، قد يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى توقف هجمات الحوثيين وحزب الله، مع أن بعض المحللين يرفضون هذا الادعاء. ومن غير المرجح أن يدعم أنصار الحوثيين، بمن فيهم إيران، استمرار الهجمات على السفن بعد وقف إطلاق النار. على المدى البعيد، إذا شن الحوثيون حملة مماثلة في المستقبل، فقد لا تحظى بنفس الشعبية المحلية والإقليمية، إذ يؤثر الاضطراب في البحر الأحمر سلبًا على الجماهير المحلية ويُقلل من تدفق المساعدات.
الاعتبارات الإقليمية
لفهم الصراع في اليمن والهجمات الحالية فهمًا شاملًا، من المهم مراعاة السياق الإقليمي. فقد استغلت عدة جهات إقليمية الحرب في اليمن لتحقيق مآربها الخاصة منذ تدويل الصراع عام ٢٠١٥.
الإمارات العربية المتحدة
دخلت الإمارات العربية المتحدة الصراع في البداية بتحالف مع السعودية في مارس 2015. رأى ولي عهد أبوظبي آنذاك، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الإمارات منذ عام 2022، في المشاركة الإماراتية وسيلةً لتوطيد علاقة وطيدة مع ولي العهد السعودي الصاعد، محمد بن سلمان آل سعود، وتعزيز نفوذه في المستقبل. وقد شكّلت هذه الحملة تحديًا كبيرًا للدول المشاركة، بما في ذلك الإمارات، التي واجه رئيسها انتقادات محلية من قادة إماراتيين آخرين بسبب ما لحق بسمعتها الدولية من أضرار جراء سقوط ضحايا في حرب اليمن.
بحلول عام ٢٠١٩، بدأت الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من اليمن، كما فعلت في مناطق أخرى بالشرق الأوسط، مثل ليبيا، حيث تدخلت في ديناميكيات ما بعد الربيع العربي، وتحولت إلى موقف أكثر تحفظًا واستدامة. مع ذلك، لم تنسحب الإمارات العربية المتحدة تمامًا من اليمن، وتحافظ على مصالحها الاقتصادية ووجودها غير المباشر في جنوب اليمن ومنطقة البحر الأحمر الأوسع.
الدافع المهم الآخر لانخراط الإمارات العربية المتحدة في اليمن هو محاولة ترسيخ قدرتها على استغلال حقول نفط مأرب-الجوف، وكذلك خط الأنابيب الممتد من هذه الحقول إلى المحيط الهندي، والحفاظ عليها، وزيادتها، وإقامة نوع من النفوذ السياسي على الأراضي التي كانت تحتلها سابقًا محافظة حضرموت، والتي اعتقد الإماراتيون أنها ستبرز مرة أخرى كخليفة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة (1967-1990). ويتجلى ترسيخ هذه المصالح الاقتصادية في عدم اهتمام الإماراتيين بالجمهورية العربية اليمنية السابقة في الشمال، وتركيز جهودهم على الأراضي التي يسيطرون عليها حول حقول نفط مأرب-الجوف، والمحافظات الجنوبية، والجزر الرئيسية، مثل بريم.
حاليًا، تخوض الإمارات والحوثيون حالة جمود طويلة الأمد ومستقرة نسبيًا في منطقة مأرب، حيث لا يزال الحوثيون متمركزين في الجبال المحيطة، لكنهم غير قادرين على مغادرة هذه المنطقة، ولا تزال خطوط الأنابيب تحت سيطرة الإمارات، واسميًا، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم منها. ومع ذلك، من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الوضع، إذ لا يُظهر الحوثيون أي بوادر للتخلي عن طموحهم بالسيطرة على هذه المناطق، بينما لا تُظهر الإمارات أي بوادر للتخلي عنها.
المملكة العربية السعودية
في البداية، رأى محمد بن سلمان في الانخراط في حرب اليمن فرصةً لمواجهة الحوثيين، الذين اعتبرهم تحديًا للمصالح السنية في اليمن، وممثلًا للشيعة إقليميًا. إن الفشل في تحقيق الأهداف العسكرية وهزيمة الحوثيين يعني أن السعودية تنظر إلى اليمن بشكل متزايد ليس فقط كمصدر تهديد استراتيجي وخطر على البنية التحتية السعودية وثقة المستثمرين، بل أيضًا كمكان يمكن فيه تقليل هذا الخطر.
منذ عام 2021، اتبع السعوديون استراتيجية تقليل المخاطر تجاه إيران بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الحوار السياسي الجاري في اليمن. وفي إطار هذه العملية، ليس من الواضح ما إذا كان أي من الأطراف المعنية يعتقد أن هناك نتيجة محتملة للسلام في اليمن من خلال التفاوض. ومع ذلك، يسعى كل طرف إلى هذه العملية بسبب تصور فردي للمكاسب الاستراتيجية المحتملة لموقفه. على سبيل المثال، فإن مشاركة السعوديين في هذا الحوار السياسي منذ عام 2021 جعلتهم أقل تهديدًا للحوثيين، وفي المقابل، حققت المملكة العربية السعودية هدفها المتمثل في تقليل المخاطر المادية والمتصورة على أمنها. يتطلب تحقيق رؤية 2030 مبالغ طائلة من النقد، ويُعد تقليل المخاطر عنصرًا أساسيًا لضمان ثقة المستثمرين العالميين وشرائهم، وخاصة بالنسبة لـ “المشاريع العملاقة” على طول ساحل البحر الأحمر السعودي، على بعد مئات الأميال شمال الحدود مع اليمن.
واجهت عملية السلام في اليمن تحدياتٍ بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. في البداية، حذّرت السعودية الولايات المتحدة من أي ردّ عسكري خشية أن يُعجّل ذلك بعودة الهجمات الحوثية-الإيرانية على الأراضي السعودية. لم تقع أي هجمات واسعة النطاق من هذا القبيل، باستثناء بعض المناوشات الطفيفة على طول الحدود السعودية-اليمنية. عمومًا، نجح السعوديون في تجاوز هذه المرحلة، وتقبّلوا إجراءات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد الحوثيين، دون تأييدها بما يجعل السعودية هدفًا أو يربطها بالتحالف نفسه.
عُمان
تحتل عُمان موقعًا استراتيجيًا رئيسيًا في هذه الديناميكيات. وسعيًا منها إلى أداء دور الوسيط، جعلت عُمان نفسها محورية في الحوار السعودي مع الحوثيين، وحيوية بشكل غير مباشر في الرسائل الأمريكية مع إيران. وبجعلها نفسها أساسية في هذه العمليات، تسعى عُمان إلى ضمان حمايتها. ورغم توتر العلاقات بين عُمان والمملكة العربية السعودية في الماضي، إلا أن العلاقات الثنائية تحسنت منذ عام 2019. ومع ذلك، لا تزال عُمان حذرة من المملكة العربية السعودية. فمن وجهة النظر العمانية، تُعتبر المملكة العربية السعودية دولة متغطرسة وقوية، وقد تسعى إلى الهيمنة على قوة أصغر وأفقر في المستقبل القريب. وتنظر عُمان إلى علاقتها المزدهرة مع إيران على أنها توازن طويل الأمد لهذا التهديد، وضمانة بأن الدول الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، لن تتحدى عُمان أو تهددها خوفًا من انتقام إيران. ومؤخرًا، في سياق الهجمات البحرية، استُخدمت عُمان كقناة للتواصل الدبلوماسي مع إيران، على الرغم من أن إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي دون وقف إطلاق النار في غزة أمر مشكوك فيه.
مصر
على الجانب الآخر من البحر الأحمر، كان الوضع في اليمن صعبًا على مصر. في عام 2015، ومع اشتداد الصراع في اليمن واستعداد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للتدخل، طُلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الانضمام إلى الحملة. وقد وضعه هذا في موقف صعب لأن حكومته كانت تتلقى تمويلًا من أبو ظبي. ومع ذلك، بعد التجربة الكارثية التي خاضتها مصر في الحرب الأهلية في اليمن في أوائل الستينيات، عندما دعمت الجمهورية العربية اليمنية ضد الإمامة، لم يكن السيسي راغبًا في خوض حرب برية أخرى في اليمن. أثار رفض الرئيس المصري غضب الإمارات العربية المتحدة لفترة من الوقت، مما تسبب في قطيعة شبه كاملة بين الجانبين. بعد ذلك، قدمت مصر وجودًا بحريًا شكليًا – ولكن لم تقدم أبدًا قوات برية – وهو ما لم يكن له في الواقع علاقة كبيرة بالصراع نفسه. في النهاية، عرضت السعودية والإمارات العربية المتحدة على مصر الدعم الكامل لأن استقرارها حيوي لهاتين الدولتين وكذلك لأوروبا.
على المدى البعيد، دفعت مصر ثمنًا باهظًا لتهربها من الصراع: إذ لم يعد لها دور في تخفيف حدة الوضع، رغم أن الصراع المطول يؤثر سلبًا على البلاد. في الربع الأول من هذا العام، انخفضت إيرادات قناة السويس المصرية – وهي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد – بنحو 50% . تزامن ذلك مع انخفاض حاد في إيرادات مصر من الهيدروكربونات، حيث أدى الاستهلاك المحلي وتراجع الإنتاج إلى عجزها عن تصدير كميات كبيرة من الهيدروكربونات لتحقيق الربح. وبدون إيرادات الهيدروكربونات، أصبحت القناة الآن أهم مصدر دخل لمصر.
خاتمة
قد رفعت حملة الحوثيين ضد الشحن البحري من مكانة الجماعة كخصم لإسرائيل مستعد للرد على الضربات الإسرائيلية غير المتناسبة على غزة، والتي كانت في حد ذاتها ردًا على هجمات حماس في 7 أكتوبر. تمكنت حملة الحوثيين من فرض اضطرابات انتقائية على السفن والبضائع المرتبطة بإسرائيل وأنصارها، مع السماح لشركات النقل غير التابعة لها بالمرور الحر. على هذا النحو، فإنها تشبه شكلًا جديدًا وربما فريدًا من العقوبات الاقتصادية المستهدفة. لم ينجح الرد الدولي على الهجمات في وقفها وقد لا ينجح حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، أو حتى تفرض إيران ضغوطًا كافية على الحوثيين للتراجع – أو كليهما. في غضون ذلك، سمحت حملة البحر الأحمر للحوثيين وإيران بالسعي إلى تحقيق أهداف متوافقة تقوض المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، بينما نأت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنفسها عن الانخراط في الصراع.
https://www.bakerinstitute.org/research/blowback-gaza-geopolitics-houthi-red-sea-campaign